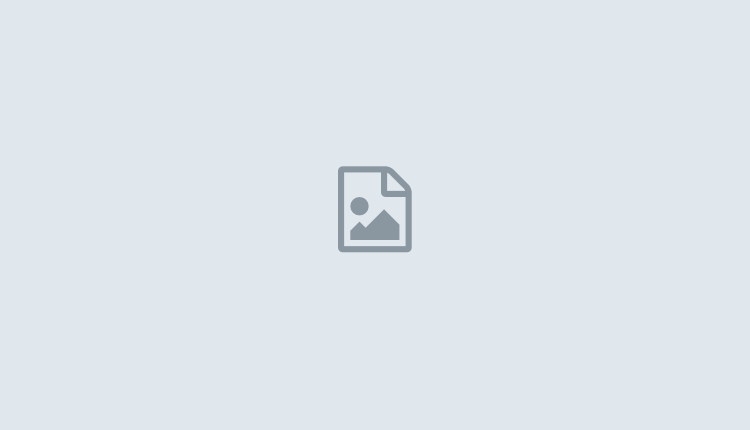د. هند عبد الحليم محفوظ: الرؤية والحل .. في رواية ” صديقتي اليهودية “
القاهرة – د. هند عبد الحليم محفوظ:
تعكس رواية الكاتب الأردني صبحي فحماوي ” صديقتي اليهودية ” التطور الناضج في أدوات الكاتب بعد تسع روايات وست مجموعات قصصية . وتعد هذه الرواية من أفضل أعماله على الإطلاق بعمقها السوسيولجي التحليلي ، وبنائها الدرامي القوي .
بطل الرواية ” جمال قاسم ” مهموم بالقضية الفلسطينية ،وينطلق في رحلة سياحية إلى عدد من الدول الأوروبية ويلتقي بالشخصية النسائية التي تقاسمه بطولة العمل، اليهودية المكسيكية من أصل ألماني ” يائيل “.. يتعرفان على بعضهما ويتبادلان الآراء حول أصل اليهود ونشأتهم وصولاً إلى الصراع العربي الإسرائيلي، والذي رسخ شعار” أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ” ذلك الشعار المرعب الذي انطوى على إنكار وجود الشعب الفلسطيني ، وتضمن طرده من وطنه بالقوة .
وقد اهتم الكاتب بتدوين التاريخ الفلسطيني عبر مراحله المختلفة بهدف توثيق الذاكرة الفلسطينية وضمان استمرارها عبر الأجيال ، وحرص على إحالة الأحداث في الرواية إلى واقع تاريخي محدد مليء بالمعلومات ، كما يحضر المؤلف الذي يخاطب القارىء أو يعترف بأن الشخصيات متخيلة، بينما ما تتناوله الرواية من أحداث هي وقائع حقيقية تدور في أماكن واقعية.
وقد تعرض الكاتب بالوصف للمدن والبلدان التي زارها مع وصف للأماكن الأخرى التي شاهدها إبان تنقله من مدينة إلى أخرى . وقد ضمن هذا الوصف ، بالإضافة إلى المشاهد الاجتماعية والمعمارية ، بعض الملاحظات حول الجوانب التاريخية لكل مدينة. كما تطرق إلى الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والنباتية لبعض البلدان .
وقد تراكم لدى الكاتب العديد من الخبرات بفضل رحلاته الاستكشافية حيث زار تقريبا معظم دول العالم ، أفضل من الكاتب الذي يجلس على أريكته في عمان أو القاهرة ، تجربة عملية من خلال رحلة فعلية في هذا المجال الخارجي، ومعايشة واقعية لأهله . فصارت آراؤه ومواقفه أكثر صلابة ، وتأثيره أكثر عمقاً وأبقى أثراً لدى القراء وصانعي القرار من آراء ومواقف نظيره الأديب ” المحض ” .
وتثير الرواية دهشة من يقرأ للكاتب لأول مرة تلك الطاقة المتجددة الحيوية والقدرة على الحكي والتلاعب بوسائله بمهارة وتضفيره بأبنية متعددة ، ومن مصادر شتى وتوظيف الجميع لخدمة أهداف سياسية لا يقف الكاتب فيها على الحياد.
ويمثل الإيقاع السردي محوراً أساسياً داخل بنية الزمن السردي ، بصفة عامة ، فلا يمكن أن نجد سرداُ بلا إيقاع ، والبنية السردية للرواية تميل إلى الإيقاع المتوسط ؛ وذلك لطول المشاهد الحوارية ، فقد وصل الحوار إلى درجة عالية من التكثيف والشعرية، وكشف الكاتب من خلاله عن مكنونات النفس العربية واليهودية والغربية كذلك في جميع أحوالها، وكثرة القفزات الزمنية، والاختصار.
ولغة السرد في الرواية ليست لغة محايدة ، وإنما لغة مشحونة جمالياً معرفياً .
لقد نجحت ” صديقتي اليهودية ” في الكشف عن حس عروبي خاص – لديً – كنت قد حسبته مات واندثر تحت وطأة ما نشهده من أحداث ، لكنني اكتشفت أنه أشبه بالنار تحت الرماد ، دون أي ادعاء أو افتعال لموقف حزبي أو جبهوي يصم نفسه بالقومية أو العروبية .فعندما صعد البطل ” جمال قاسم ” الحافلة في ساحة بيكاديللي وسط لندن وكان هو العربي الوحيد في هذه الرحلة صهلت امرأة غربية :” صدام حسين ! صدام حسين! ” وارتسم التوتر على ملامح الوفد السياحي الذين شنفوا آذانهم وجحظت أعينهم لمشاهدة هذا الإرهابي العربي.
وينتقد الكاتب وصف الغرب للعربي المسلم بالإرهابي عبر المونولوج الداخلي فيقول:
“في هذا العصر الذي وسموه ظلماً ب( الإرهابي العربي الإسلامي ) وألبسونا إياه زوراً وبهتاناً بهدف شيطنتنا ، بعد احتلال كامل تراب فلسطين ، ودفع تحالف أكثر من ثلاثين دولة لتحطيم عراقة العراق ، ومن ثم سائر البلاد العربية . وذلك على مبدأ ” رمتني بدائها وانسلت “.
وانتهز الراوي فرصة مرور الحافلة فوق جسر لندن ، الذي يعتبر من أشهر معالم العاصمة بجوار البرلمان ومجلس الشيوخ البريطاني ، وهو واحد من ضمن ثلاثة وثلاثين جسرا تقطع نهر التايمز في لندن . فاستدار إلى المرأة التي وصفته بالممثل الشرعي لصدام حسين قائلاً :
هل سمعت ما قالته المضيفة عن ثلاثة وثلاثين جسراً تقطع نهر التايمز وفوجئت بالسؤال قائلة : نعم سمعت . فقال لها : هل جاءكم أي عربي ، فحطم جسراً واحداً من هذه الجسور الإنجليزية العتيدة ؟
فقالت : لا ، لم يأت .
فقال : كل ما كان عندنا في بغداد هي خمسة جسور لا نملك غيرها .. أتيتم بعديدكم وعتادكم ، مدججين بثلاثين دولة غربية معتدية ، فحطمتم الجسور الخمسة اليتيمة لدينا بدون أي مبرر، بينما لم تخجلوا بوصم العرب بالإرهاب .. ترى من هو الإرهابي ؟!
فامتقع وجه المرأة بألوان الإحراج السبعة ولم تحر جواباً .
نحن إذاً بإزاء عمل يثير من التساؤلات منذ الصفحة الأولى وحتى الصفحة الأخيرة من الرواية ، شيئاً كثيراً ، ولن ينجح المتلقي الذي يكتفي باستهلاك الدلالة ، أن يصمد أمام بنائها المركب الذي يزخر بالضجة والازدحام .
وسوف أتوقف عند البناء السردي للرواية بشيء من التفصيل . فالرواية يضم فضاؤها زخماً لافتاً من الأحداث والشخوص ، وتعدداً هائلاً في الأماكن ، ثم وهذا هو الأهم إتيان عناصر البناء السردي مثقلة بثقافاتها النوعية قديماً وحديثاً ، مع خطين أحدهما سياسي والآخر معرفي يتم تضفيرهما مع باقي العناصر، عبر مختلف المذاهب العقدية والسياسية .
أما كيفية تقسيم صفحات الرواية فقد أتى على هيئة طرقات على جدار الذاكرة، تنهمر بعدها الأحداث عن طريق التداعي. ومن هنا كان لحقل السيولة الدلالي حقيقة ومجازاً تأثير كبير في تقسيم الرواية.
ويأتي أسلوب الحكي داخل الحكي ، عن طريق احتواء الرواية على أكثر من قصة ، بل أكثر من فضاء روائي كامل بوصفه عنصراً مميزاً لهذه الرواية ، مما جعل الرواية شديدة التعقيد والتشابك وبخاصة أن الكاتبة لا تستبعد أياً من شخوص الرواية الكثيرين وتتداخل شخوص المحكي الأصلي مع الفرعي .
فالحكي ورد متدفقا عبر راوٍ يعمل مهندساً زراعياً ، استطاع تمرير حميع الأحداث الكبرى عبر عيونه ورؤيته هو . وهذا الراوي له صلاحيات كبيرة في السرد سمح له بإدارة كل الفضاءات وعبر كل الشخوص والأماكن ، كما سمحت له هذه الصلاحيات بتمرير آرائه ومعتقداته السياسية والدينية من خلال المادة المحكية ففي حواره مع المرأة اليهودية رفيقته في الرحلة ” يائيل ” التي عاشت حياة بائسة في بداية حياتها وأنجبت طفلين يدرسان في المدرسة التي تتولى إدارتها وأعربت عن أمنيتها أن يكبرا ويتخرجا من المدرسة ، فترسلهما إلى “إسرائيل” .
ويناقشها بطريقة عقلانية قائلاً : كيف تربي الأم أولادها ، حتى يكبرون ويزهرون ، ثم توجههم إلى بلاد بعيدة ، والمصيبة أن هذين الشابين سيأتيان إلى فلسطين بكل طاقتهما البكر ، وبدلاً من أن يتعلما المحاماة أو صناعة المجوهرات ، ستجدينهما يتعلمان الكراهية والحقد والعنف ، ويتدربان على أعمال القتال ويمارسان جرائم القتل والتدمير في فلسطين ، وبدلاً من أن يجري الذهب في أيديهما ، ستجري بين أيديهما دماء غزيرة .
ويستمر الجدل بينهما، فتشمئز″ يائيل” قائلة : لا تقل تدميراً .. نحن اليهود نريد أن نجد مكاناً تحت الشمس . . نريد ان تكون لبني إسرائيل دولة نسميها إسرائيل .
فيقول : لا تقولي إسرائيل .. قولي فلسطين
فتقول : لا تقل فلسطين .. قل إسرائيل .
فيقول : ” إذا كان نص وعد بفلور الذي أسس إسرائيل بقوة الحرب العالمية ، يقول : وطنا قومياً لليهود في فلسطين ، فكيف تقولين في إسرائيل .
ويستمر الجدل بينهما على هذا المنوال .
والمكان لا يأتي بوصفه مكانا فقط ، بل هو وعاء ثقافات ،وانتماءات عرقية وعقائدية دينياً وسياسياً ، فالمكان مثقل بثقافاته المتنوعة القديمة والحديثة في لندن وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج والأندلس .فعلى أرض كل دولة ثقافتها الشعبية والرسمية ، وأعرافها وأحلامها ، ورؤيتها للعالم .
أما زمن الرواية فهو النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي ، حيث تداعيات معاهدة أوسلو 1993م ، وحرب الخليج الأولى ، والتضافر العربي لإزاحة العدوان والاحتلال، غير أن الزمن المعاصر يختلط ويتشابك بشدة مع أزمنة سابقة ، بعضها في الماضي القريب ، والآخر يمتد إلى آلاف السنين ، حيث اشتهر اليهود بتزوير وقائع التاريخ ونسب أمجاد الآخرين إليهم ففي معرض حوار جمال قاسم مع يائيل يقول : ” لقد عاش الكنعانيون في فلسطين منذ عصر الإنسان الأول ، وأما يهود الخزر الأوروبيين ، فلقد قام كتّابهم وفلاسفتهم بقراءة تاريخنا الكنعاني في غفلة من الزمان ، فاستنسخوه ، ثم وضعوا اسمهم مكان اسمنا .. لقد ساروا على خطانا ، ولكن بممحاة ، تزيل كل اسم ” كنعاني ” ، أو فلسطيني فتضع مكانه اسم إسرائيلي ” .
واللافت هنا أنه مع تشقق المكان على النحو الذي مر بنا، يتشقق الزمان أيضاً ما بين لحظة آنية ترتد بسرعة إلى استدعاء التاريخ وأحداثه الماضية ، ومع تداخل الحكي داخل الحكي تتعدد الفضاءات الروائية ، وتتعدد الأزمنة والارتدادات إلى الخلف مما أثر بشدة كذلك على طريقة وسير خطوط السرد التي جنحت في الفقرة الواحدة نحو اللحظة الآتية والفلاش باك واللحظة الآتية مجدداً ، ففي معرض الحديث عن الجولة السياحية في هولندا شاهد جمال قاسم ويائيل العمال وهم ينثرون البول ، ومخلفات روث الأبقار ، السيئة الرائحة ، على مزارع أبصال الزهور، المتوقع أن ، تنتج زهوراً فواحة .
وينتهز جمال قاسم الفرصة على طريقة الشيء بالشيء يذكر ، فيحكي ليائيل “قيام جهاز الأمن الإسرائيلي برش القاذورات وسوائل البول والمجاري بخرطوم بعيد الدفع على شرفات بيوت الفلسطينيين ، وشبابيك منازلهم وجدارنها ، لإذلالهم ، وتحطيم كرامتهم ، وتبديد طاقتهم التي تتظاهر ضد بطش الاحتلال الغاشم ، ولتضييق الخناق على عيشهم واضطرارهم للرحيل من بيوتهم ليحتلها الإسرائيليون ” .
وتستنكر يائيل هذه الممارسات قائلة : أمعقول كلامك هذا ؟!
ويجيب : افتحي على ” يوتيوب ” وشاهدي تلك المناظر بأم عينك ” .
فإذا حدث هذا في أكثر من فضاء روائي كبير ، وعشرات القصص الفرعية ، فأي تعقد وارتباك سوف نقابله .
كما أن الزمان والمكان كلاهما يتميز بواقعية شديدة مستمدة من أحداث ووقائع حقيقية ، بل وشخوص حقيقية .
ومن الصعب على المبدع العربي أن يخرج من قهر التاريخ ويحرر ذاكرته من أوجاعه ، لهذا نستطيع أن نفهم لماذا تقهقرت إمكانية رسم صورة إيجابية للآخر، عندما تم التنكيل بالبطل “جمال قاسم ” من قبل مجموعة من الشباب الإنجليز (الهوليجانز) المتعصبين لمنتخب بلادهم عقب هزيمة منتخب إنجلترا في بطولة الأمم الأوروبية واعتقدوا أن قاسم فرنسي الجنسية ، مما جعله يتعرض للموت المحقق على شاطيء” بورتسموث “
فما بالنا لو اكتشفوا أنه عربي الجنسية ؟ !
كما تعرض الكاتب للمضايقات الأمنية التي واجهها البطل في مطار لندن لمجرد أنه عربي .
وعلى مدار الرواية قدم الكاتب مشاهد تتيح لنا معايشة علاقة إنسانية مدهشة بين الأنا المسلمة ” جمال قاسم ” ، والآخر الذي تجسده اليهودية ” يائيل ” ، وقد جمعهما الانتماء إلى فضاء مكاني واحد هو ” أوروبا ” وتقوم هذه العلاقة على الحب والتفاهم ، إذ لم يشكل اختلاف الدين عائقاً لها !
لذلك سنجد الاسم ” صديقتي اليهودية ” احتل موقع الصدارة في العنوان نظرا إلى أهميته .ووصفها بالصديقة لنفي أي انطباع سلبي عنها .وبلغ هذا الحب أقصى مدى حين أضاف اليهودية إلى الذات العربية ( عبر ياء المتكلم : صديقتي ” ، وبذلك تبتعد عن العنوان الظلال المشوهة ذات الأبعاد السياسية التي قد تتوارد إلى الذهن ، فتبتعد بالتالي عن مخيلة المتلقي، الدلالة السلبية التي تلحق عادة الأيديولوجية الصهيونية المتسترة بالدين اليهودي ، وتفلح الرواية في ترسيخ الدلالة الإيجابية .
ومما يحسب للرواية أنها تجاوزت هيمنة الصوت الذكوري ، حيث يمنح المؤلف الرجل البطولة الروائية، لكن في هذه الرواية تقاسمت المرأة ” يائيل ” البطولة مع ” جمال قاسم ” وقد بدت شخصية رئيسة نقيضة للصورة النمطية للمرأة الشرقية سواء أكانت يهودية أو مسلمة ، لهذا استطاع الروائي أن يجسد عبر أقوالها وأفعالها ، قدرة العقل المنفتح على التغيير ، باعتماده على المعرفة والحب ، وقد أتاح للمتلقي ، عبر هذه الشخصية وفاعليتها ، معايشة آليات هذا العقل ، الذي ينطلق من مبدأ التعامل الندي بعيداً عن لغة الاستعلاء ، فهي تحترم ثقافة الآخر ، وتنظر بندية إليه ، فتهتم بأن تتبادل معه المعرفة .
كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر