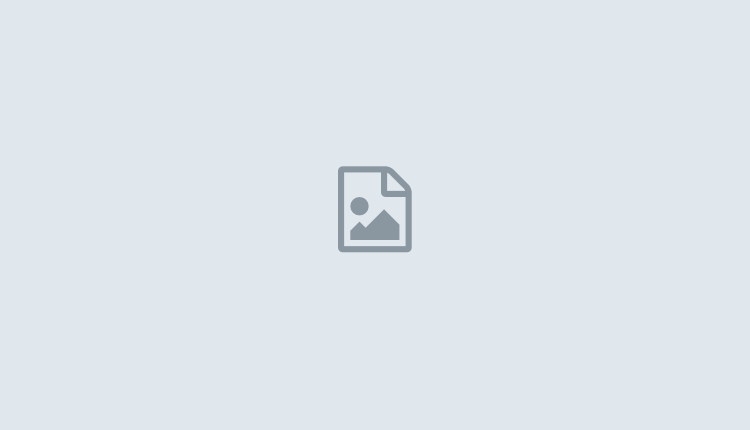فؤاد الخطيب.. الشاعر الـذي أراد أكثـر مـن نهضـة
د. فيصل درّاج * الوجه البارز في شباب الخطيب لا يقتصر على تعليمه المتفوق بل اندراجه المبكر في ممارسات معادية للاستبداد التركي، جعلته نصيراً حاسماً للثورة العربية الكبرى وصوتاً شعرياً عالياً لها. الذي يتردد على «دارة الفنون» مؤسسة خالد شومان الثقافية يقرأ على الجدار المفضي إلى «دار خالد»: سكن في هذه الدار فؤاد الخطيب شاعر الثورة العربية الكبرى. قد يعرف الإنسان العادي معنى «الثورة العربية الكبرى» التي قادها الشريف حسين ضد الحكم التركي، واعداً بتحرير العرب من الاستبداد وبتحقيق استقلال أرضهم، وبإقامة دولة عربية موحّدة، تحقق للعرب ما يتطلعون إليه. لكنه لن يعرف، بالضرورة الشاعر الثائر، فقد توفي قبل تسعة وخمسين عاماً، وذهب السياق الذي فرض عليه قصيدة وطنية، مع أمور كثيرة ذهبت، ليس آخرها «شاعر القبيلة»، الذي ينصب ذاته ناطقاً باسم قومه، يذكر فضائلهم، وصوتاً مندداً بأعدائهم. غير أنّ الذي يعود إلى سيرة هذا الشاعر، الذي جمعت قصائده في كتاب ضخم عنوانه: ديوان فؤاد الخطيب، يقف أمام شخصية جديرة بالاحترام، لا تنقصها غرابة الأقدار: كان عروبياً في زمن لم تكن فيه «العروبة» تهمة، ومثقفاً ثائراً ينصر العدل ويندد بالظلم، وإنساناً طليقاً، ينتنقل من بلد إلى آخر ملبياً ما اعتقد به. وكان فوق هذا وذاك ملتزماً «بفلسطين»، يزجر من صادرها، ويحرّض على نصرتها، ويرى في مآلها الأخير مرآة «للعرب»، تلك الكلمة الفضفاضة التي اتسعت لاحتمالات كثيرة. ولد فؤاد الخطيب في بلدة شحيم من قضاء الشوف اللبناني، عام 1893، في أسرة مصرية الأصل، عرفت باهتمامها بشؤون الدين واللغة، ما دفعه إلى الاهتمام بالأدب العربي والشعر فدرسه في الجامعة الأميركية في بيروت، وأنهى دراسته متفوقاً، وكان من زملائه في الجامعة فيليب حتّي وبندلي الجوزي وأنيس المقدسي، وهم باحثون كبار اشتهروا في مجالاتهم المتنوعة. وربما أوصله التزامه العروبي، كما نظره الثائر، إلى مدن عربية متعددة، فدرّس اللغة العربية في يافا، ومرّ بالقاهرة حيث عاش مع شاعر النيل حافظ إبراهيم في غرفة واحدة، واختلف إلى الخرطوم ودمشق، وعاش في الحجاز، وانتهى إلى كابول سفيراً فوق العادة للملكة العربية السعودية في افغانستان، وتوفي وهو في منصبه الأخير. غير أنّ الوجه البارز في شبابه لا يقتصر على تعليمه المتفوق، بل اندراجه المبكر في ممارسات معادية للاستبداد التركي، جعلته نصيراً حاسماً للثورة العربية الكبرى، وصوتاً شعرياً عالياً لها. أسّس مع غيره حزب «الاتحاد اللامركزي»، الذي التزم بالهوية العربية وغدا عضواً بارزاً في جمعية المنتدى العربي التي أنشئت عام 1909، وطالبت الأتراك بإعطاء العرب حقهم في الحرية والاستقلال وحفظ كيانهم القومي ولغتهم العربية. ولعل انتسابه إلى عمل كفاحي لا تنقصه السرية، كما وعيه بهويته القومية، هو الذي دفعه إلى تمثّل عميق للغة العربية، وإلى اختيار الشعر وسيلة قومية للتعبير، متابعاً تقليداً عربياً قديماً، مقترباً من الشاعر المصري سامي البارودي، الذي صاغ القضايا الراهنة بلغة جزلة، مستلة من ديوانه الشعري القديم. وبسبب التزامه القومي الصريح، كما دروه التحريضي، حكم عليه بالإعدام بأمر جمال باشا السفاح، الذي بهرته لاحقاً يهودية جميلة تدعى سارة سانسون، أهداها ضابط المخابرات الإنجليزية توماس لورانس كتابه: أعمدة الحكمة السبعة. عرف مصر وتعرّف فيها على شعراء كبار، وتعرّفوا عليه، مثل إسماعيل صبري وأحمد شوقي وخليل مطران، وأقام في السودان مدرّساً للغة العربية في كلية «غوردون». انتقل فؤاد الخطيب إلى الحجاز حيث اتصل بالشريف حسين بن علي، وعيّن وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة «النهضة» عام 1916، حين أعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك، فوزيراً للخارجية. رأى الشاعر في الثورة حلماً سعى إليه طويلاً، فأخلص لها ونظم فيها ما شاء من الشعر حتى لقب «بشاعر الثورة العربية» و»شاعر العرب»، ما جعل منه رائداً من رواد القومية العربية وقصيدة الالتزام، أو الشعر الملتزم، كما يقال بلغة تبدو غريبة اليوم. وحين نودي بفيصل الأول ملكاً على سورية، عهد إليه بوزارة الخارجية، وسافر معه إلى لندن لحضور المؤتمر التمهيدي للصلح، وكان معه في مؤتمر فرساي، وغادر سورية بعد الاحتلال الفرنسي عام 1920، وذهب إلى الحجاز، حيث عيّن وزيراً للخارجية في المملكة العربية الهاشمية. وفي إطار حياته الحافلة صار مستشاراً خاصاً للأمير عبد الله (ملك الأردن في ما بعد). وحين احتج البعض على قصائده الوطنية، الموغلة في الغضب، تصدى لهم الأمير طلال (ملك الأردن في ما بعد) وقال: إنه شاعر الثورة ولسان حال الأمة العربية، فليس لأحد أن يعترضه أو أن يحاول إسكاته، وهل كان بوسع أحد إسكات شكسبير؟» ومهما يكن من تطوافه الواسع، والمناصب العديدة التي تبوأها، فقط ظل شاعراً في الممارسة والمنظور، وهو الذي نظم الشعر في الثانية عشرة من عمره، وكان راوية يحفظ الكثير من اشعار العرب وتلازمه مكتبة كبيرة. أصدر «ديوان الخطيب» الأول، وهو من بقايا شعره التي سلمت من «الإتلاف»، لاعتبارات سياسية، ومسرحية «فتح الأندلس… أما كتبه عن الشعر واللغة وتأمل الحياة، فلم تحظ بنصيبها من «الطباعة اللائقة» حتى اليوم. وربما تعطي بعض السطور التي كتبها فؤاد الخطيب مقدمة للجزء الأول من شعره صورة عن لغته الكلاسيكية وثقافته الواسعة، وتأسيه على انحطاط العرب وتهافت مصائرهم، وذلك الحنين الحارق إلى ماضٍ عربي كانت «بغداد فيه ندوة علمية»، وعن إيمانه بدرو الشعر في أيقاظ العقول، وصقل الهمم، وكذلك دور اللغة العربية في تحضير أوروبا النهضة. يقول في نهاية تقديمه للجزء الأول من ديوانه: «هذا ما نقوله عن أجدادنا القدماء فتنزو بنا سورة التيه والخيلاء، فليت شعري ما الذي يقوله عنا أبناؤنا في مؤتنف الأيام، وهم لا يرون في تاريخنا غير الجمود والانقسام؟ أيستنزلون علينا غوادق الرحمة أم صواعق النقمة؟ ألم يكفنا تخاذل الحزم وقصود العزم؟ حتى أضعنا كنوز الآداب، ولهونا بالقشور عن الباب، وتركنا كتب آبائنا في خزائن الغرب، وبتنا في نعمة بال وراحة قلب. نعم إن الدهر ليضنّ بدفن تلك الكنوز في مطاوي النسيان، فنقلها من بين أيدينا إلى أوروبا وأودعها المكاتب أو أديار الرهبان، إلى أن نسير على هدى أجدادنا، ونعمل على إحياء أمجادنا، فترد إلينا بضاعتنا غير مزجاة، وتكون إلى العلوم خير مرقاة..». لغة كلاسيكية، مشدودة إلى القديم، حايثت عقلاً إحيائياً يحاور الماضي كي يصل إلى المستقبل، أو يحاور الأخير مستنجداً بما كانه العرب في فترة مضيئة من تاريخهم، مستشهداً «بالنهضة الأوروبية» وبالأسباب التي صنعتها. جسد، حال خليل مطران وحافظ إبراهيم ومحمد المويلحي، مرحلة فكرية انتقالية، مستنجداً بلغة قديمة، وتؤمن بالقديم المتجدد طريقاً إلى زمن عربي جديد. ولذلك كان إحيائياً في شعره ومنظوره ونهضوياً في غاياته، يكره الجمود والثبات وينفتح على المستجدات، وينفتح أكثر على ما يجب القيام به. أملى عليه وعيه القومي العربي قصائده، مؤكداً أن دور الشاعر في ما يتطلع إليه. حين تخلّف عن حضور المهرجان الذي أقامته مصر وشعراء الأقطار العربية تكريماً لأحمد شوقي في القاهرة، في نيسان عام 1927، لمبايعته بإمارة الشعر، أرسل إلى الشعر المحتفى به، الذي عتب عليه، قصيدة عنوانها: إلى شوقي، جاء فيها: «لكل فتى في العرب مصران داره/ ومصر ملاذ المستضام وكافله. فيالك من يوم أغر محجّل/ أوائله افترت وسرت أصائله. تصافح فيه العرب تحت لوائهم/ وفي البلد المرجو للعرب عاهله. يد لك يا شوقي على الشرق باركت. ولم تأل جهداً في الجهاد تواصله». رأى في شوقه شعره المجيد، ورأى فيه ناطقاً «بام اللغات»، أي اللغة العربية، منتظراً «أم الأمم»، التي عبث بها التفكك والأجنبي القوي. ولعل غضبه على ما بلغه العرب من هوان، هو الذي أفضى إلى قصيدته: المجاهد الناهض، حيث يقول: «لله در مجاهد ما يفتر/ ذيحي اللياي في الجهاد ويسهر. وكم ارتمى في السجن رهن قيوده/ وعليه من دمه القميص الأحمر. قل للمجادل فيه حسبك نظرة/ تغني اللبيب عن الجواب وتعذر. فلينظر الأحزاب أين مصيرهم/ فالجو اقتم بالصواعق ينذر. ولم التفرق والحتوف تجمّعت/ ولم التردّد والبلاد مشمر. أين الخطيب الحر ينهض بينهم/ فيهز من موتى النفوس فتنشر. واشد من صلة السياسة عروة/ صلة أحق بها الأديب وأجدر. حزب الأديب هو الجزير كلها/ هي «ندوة» وبنو الجزيرة معشر. لله كم رأت العروبة محنة/ ولكم تقدم باسمها المتأخر..». اعتقد فؤاد الخطيب أن على الشاعر أن يتوجه إلى الأمة كلها، مؤمناً بوحدة اللغة، و»بالمحنة» التي تتوحّد فيها الأمة كلها. وهو بداهة، لم يكن مكتفياً بإرسال القول، بل كان عنصراً من الأمة وفيها، مؤثراً أن يكون رائداً في الوضوح، وعلاقة داخلية في الواقع العربي المهزوم، الذي يحتاج إلى قيم وأحزاب أخرى: «أنا لست أوثر في القضية عصبة/ إن «القضية» كل ما أنا أوثر. ولقد نفضت يدي من أحزابها/ ولبثت أرقب جمعهم وأحبّر». صورة عن التحريض واليأس معاً، إذ في التحريض ما يؤكد الشاعر شاعراً، وإذ في اليأس ملاذ نظيف يستدعي لغة تتمرد على الذي يستعملها، كما لوكان في «واقع الأحزاب» ما لا يمكن النفاذ إليه. ذلك أن التحبير هو «تحسين الكلام»، الذي يشير إلى «عثار ما» تمسك به اللغة. أملى غضب الشاعر على واقع عربي لا يليق بماضي الأمة، قصيدة عنوانها: تحية النهضة، التي قالها في مكة المكرمة مرحباً بقيام الحكم العربي والدخول إلى النهضة في عام 1916، حين أعلن الشريف حسين ثورته على الأتراك: «حي الشريف، وحي البيت والحرما/ وانهض فمثلك يرعى العهد والذمما. يا صاحب الهمة الشماء أنت لها/ إن كان غيرك يرضى الأين والسأما. واسمع قصائد ثارت من مكانها/ إن شئتها شهباً أو شئتها رجما. من شاعر عربي غير ذي عوج/ قد بارك الله منه النفس والكلما. هيهات أكتب بعد اليوم قافية/ إلا إذا كان حد السيف لي قلما». عطف الشاعر ذاته الثائرة، «التي لا تعرف العوج»، على الشريف حسين، «الذي يرعى العهد والذمما»، حالماً بعربي مقاتل يرفض الضيم وينظر إلى الانعتاق. ولذلك فإن قصيدة «تحية النهضة» تنطوي على جملة من الثنائيات الضرورية: المظالم والظلم والضرب والطاغوت والضيم والشنق،.. وكل ما وصمت به القصيدة الحكم التركي من ناحية، واليقظة والانتقام والثورة ورفض الضيم والعرب الأحرار من ناحية ثانية. وواقع الأمر أن فؤاد الخطيب كان يرى ما يعيشه ويأمل بتغييره وينظمه شعراً، وكان يستعير النظم من إيقاع قصيدة عربية قديمة، لم يعش صاحبها العسف التركي ولم يسمع بأخبار «لورانس»، كأن نقرأ: «سارت مع الدهر من بدو إلى حضر/ حتى استتبت فكانت نهضة عمما. من كل أروع وثاب إذا انتسبت/ بيض الصوارم كان الصارم الخذما. إلى الشام، إلى أرض العراق، إلى. أقصى الجزيرة، سيروا واحملوا العلما. كان ينظر إلى ما يرغب به مستلهماً «الصوارم»، ومستظهراً قصيدة عربية من ماض «مجيد»، رأى فيها هوية له، وأراد أن يحافظ عليها فاستظهرها من جديد، كما لو كانت الهوية العربية القديمة والجديدة ماثلة في قصيدة نطق بها البحتري أو قال بها أبو تمام. ورغم حرصه على بلاغة متقنة الأطراف، فقد رأى اللغة العربية في أثرها العملي المجسّد بالقتال. يوقل في قصيدته «مصرع البطل» راثياً عز الدين القسّام الذي ذهب شهيداً في معركة ضد الإنجليز قرب بلدة جنين عام 1936: «كثر الكلام وما أفاد قلامة/ فتكلمت بلسانها النيران. يا حصن يعرب في ثراك موسد/ نعم الضحية عنك والقربان. هو صيحة ملأ الفضاء دويّها/ فسل «العروبة» هل لها آذان». واللافت أن الشاعر، الممتلئ بعروبته، يضع كلمة «العروبة» بين قوسين صغيرين، كما لو كانت كلمة لن تتجسّد فعلياً إلا بعد جملة معارك. ولهذا تمر القصيدة على ظواهر متعددة، يضيئها الشاعر المتمرّد بجمل قصيرة: «وجعلت لاسم «الشيخ» أرفع رتبة/ نبذت قديم عهودها الأوطان». يعود الخطيب فيضع كلمة «الشيخ» بين قوسين، مؤكداً أن للشيخ دلالة محدودة. ويقول ما قاله به غيره: «يا أيها العرب الذين تقسمت/ شتى الديار بهم وهم إخوان» أو أن يقول: «إن «العروبة» كهفكم وثمالكم/ ليست تفرق بينها الأديان». صاغ الشاعر قصائده انطلاقاً من ثنائية: الموجود، وهو مليء بالسلب، وواجب الوجود الذي ينقل اللغة من القاموس إلى الحياة، ويجعل من الحاضر المربك والمرتبك امتداداُ لماضٍ ذهب ولن يعود: «شهداء بدر والبقيع تهلّلت/ فرحاً وهشّ مرحباً «رضوان»» ولن يختلف الأمر وهو يتحدث عن «الجحافل» والسيوف المصلتة في قصيدته المنتدبين الراحلين»، راجماً وعد بلفور والذين جاؤوا به، مدافعاً عن فلسطين: «ويح العدى وسيوف العرب مصلتة/ والأهل والدار في حطم العدى شرع» ربما لم يكن فؤاد الخطيب، القومي العربي المسلم، بعيداً في تصوره للعالم عن القومي العربي السوري: زكي الأرسوزي، الذي ساوى بين العرب ولغتهم، ورأى في لغة الضاد معجزة، كما لو كانت تنصر ذاتها بذاتها، أو تنصر الناطق بها، ولو بعد حين. جاء في قصيدته: «في سبيل فلسطين إلى الناطقين بالضاد» التي كتبها إثر خروج الانتداب البريطاني في فلسطين: «لله در فلسطين التي انجردت/ إلى الجهاد فثار البأس يحتدم. فيا خطوب اعصفي ما شئت طاغية/ إني فلسطين، إني لست أنهزم. حسبي العروبة من قبل الرعاة ومن/ بعد النبوة حتى تبعث الرمم/ ليست فلسطين بالمأوى المباح لكم. ولا التي هي في الأسلاب تقتسم». جمع فؤاد الخطيب في شعره أبعاداً ثلاثة: فهو من المدرسة الإحيائية التي ذكّرت باللغة العربية واستعادتها شعراً، واستعادت معها خصوصية الشعر العربي القديم في أرقى مستوياته، على مقربة من البارودي، في زمنه، والجواهري في زمن لاحق. وهو المثقف القومي الرومانسي، حال ساطع الحصري، الذي اعتقد أن المجيد التليد يعود إلى الحاضر، إذ آمن العرب به وأخلصوا لمبادئ العروبة.. هو صاحب القصيدة المتفائلة، التي تحكي بنيتها عن تفاؤلها، التي تمر، بالضرورة، على عناصر ثلاثة: بؤس الحاضر الذي أسقط العرب وهيبتهم، الثقة بالقديم وبما كانه العرب في حقب سابقة، وتلك الإيمانية المتفائلة، التي تعطف الحاضر المقاوم على الماضي وتستولد مستقبلاً جديداً، يستعيد العرب فيه حقوقهم، ويدافعون عن الحق في كل مكان. جسّد فؤاد الخطيب المثقف العربي النهضوي في وجوهه الثلاثة الأساسية: التمسك بالهوية والبحث عن هوية قادرة على المواجهة، الإيمان بالمستقبل المنشود الذي يحمل في طياته أصلاً مجيداً قديماً، والنظر إلى الماضي والمستقبل بشيء من الأسى، فلا الماضي المجيد يعود ولا الحاضر يعد بعودة قريبة له. كان في حال شعره ما يقول: ليس على العرب أن يواجهوا بؤس الحاضر بأمجاد من الماضي، إنما عليهم أن يصنعوا مجداً في الحاضر، يكون امتداداً للماضي وتجاوزه. * ناقد فلسطيني مقيم في الأردن .