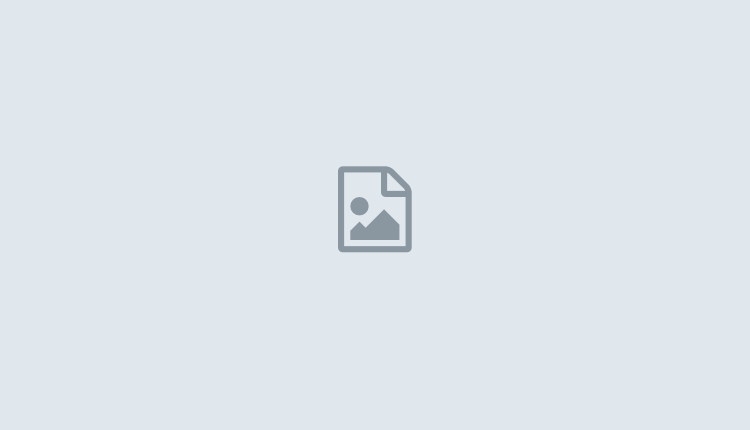صدور الطبعة الأولى من ديوان “البافور” للشاعر المختار السالم
شبكة وهج نيوز – وكالات : صدرت الطبعة الأولى من ديوان “البافور” للشاعر المختار السالم، وهو أحد وائل دواوين الشعر النثري في موريتانيا، إلى المكتبات.
ويضم الديوان 32 قصيدة، ويقع في 110 صفحات من الحجم المتوسط. وصدر عن “دار القرنين”.
وقالت وكالة أنباء إن ديوان “البافور” هو “عبارة عن قصائد نثرية جميلة باذخة..”.
وقدم للديوان الدكتور محمد بدي أبنو.
وتقول كلمات الإهداء التي كتبها الشاعر:
“إلى الكلمات المعتقلة في سجون الخليل والمتنبي والمختار السالم.. من دون ريح لا ينتفضُ الريش…”. ويعتبر المختار السالم أحد أبرز الشعراء في البلاد.
وحملت قصائد الديوان أسماء مثل: “إدانة بريئة جدا”، و”القصيدة والعصيدة”، و”تُشبهني”، و”زجاجة الصمت”، وبطالة الصهوات”، وقصيدة “ثمانية أحلام في ظلال العطور”، وحتى “على مرمى عدسة”، و”عطرُ المذيعة”، و”غارة الشنفري”، و”مسافة داخل الشاي (البائية المسحورة)”، و”الظلُّ الأحولُ”، و”دليل النجم”، و”مرثية الفراغ..”.
والشاعر المختار السالم روائي أيضا ومن أشهر رواياته “موسم الذاكرة” و”وجع السراب””.
المقدّمة
د. محمد بدي أبنو
– 1 –
عزيزي المختار السالم،
شكراً على هذا الديوان، شكراً على الرسالة وعلى المبادرة. ولكنَّ ثمَّةَ سؤالاً تلقائياً لا يمكن تفاديه بسهولة : هل يجوز تقديم الشعر؟ هل يجوز تقديم “البافور”؟ يمكن فعلاً أن يقال عن تساؤلي هذا إنه غير جدّي وإنه فقط نوعٌ من ممارسة طقسٍ تمنّعيٍ عرفيٍ يبدأ عادةً بشيءٍ من الإمتاع والمؤانسة مثل “الكلام على الكلام…”. ومع ذلك فمن الوجيه أن نلاحظ في مثل هذا المقام أنّ التقديم أياً يَكنْ يظلّ في “مستوى الماقيل” بينما الشعر معنيٌ أولاً بمستوى القول وهو بذلك مكتفٍ ذاتياً من حيث المبدأ تجاه كلّ “الماقيل” و “المايُقال”. إذا أخذنا هذا الاعتبار على محمل الجدّ فإن المسافة التي تفصل التقديم عن الديوان هي حتْماً مسافةٌ غير قابلةٍ للعبور.
– 2 –
نعم أتذكّر فعلاً رغم السفر والوجع أيامنا الأولى في بدايات النصف الثاني من الثمانينات. ولكن ما أتذكّره محدودٌ بالمقارنة مع قدرتكَ على استعادة واستنفار التفاصيل. كنّا معاً متعاونين في صحيفة “الشعب” ونعيش ما يُسمّيه والتير بنيامين بميتافيزيقا المراهقة. طبعاً “الشعب” كانت حينها الجريدةَ الوحيدةَ في البلد رغْمَ بعض التجارب الموازية التي لمْ تعمَّر طويلاً. وقد حاولنا بكلّ ما للمراهقة من حماس، بالإضافة إلى العمل الإعلامي “العرَضي”، أن نوظِّف الصحيفةَ المتواضعةَ في نشْرِ كتاباتنا الأدبية والشعرية. كان بداهةً الشعرُ العموديُ جوازَ سفرٍ ضرورياً. وهو ما يَظهر مثلاً في عملي الأول “يموت الموت”(1988) الذي نشرْتُه في المطبعة الوطنية، أي في نفس المؤسسة اليتيمة التي كانت تصدرُ عنها حينها الجريدة اليتيمة. ولكنْ إلى جانب قصائد الشعر العمودي التي تفرضُها الذائقة السائدة فإنَّ شعرَ التفعيلة ـ أو “الشعر الحرّ” وفقَ التسمية المنافِسة ـ هو الشكل التعبيري الذي كنا نُفضِّل أو نتبنّى بشغف. بل كانت لدينا رغبة في إثبات أن العمودي بحكم التاريخية الجمالية للشعر العربي غيرُ تقليدي في جوهره. أيْ أنّه يمكن أن يظلَّ عمودياً بالمعنى الوزني التقعيدي في نفسِ الوقت الذي يثور فيه، صوراً وإيقاعاً وفضاءً دلالياً إلخ، على صورته النمطية السائدة في ذلك الوقت. كنا نعتقد أنّا نجحْنا في كتابة شعرٍ عموديٍ يثور على “العمودي”، أي يستعيد الطاقة الشعرية والنسغ الإبداعي خلف القوالب التي أرادتْ المدرسيّة أن تُجمِّدها وأن تجعلَ منها حُجُباً.
– 3 –
هل اختلفتْ نظرةُ الدراسات النقديّة اللاحقة عن أحكامنا القطعية الحماسيّة ؟ الشيء الثابت على الأقل هو أن الاندفاع كان كبيراً في الثمانينات لمشروع التحديث بشكلٍ عامّ ولمفردات “الحداثة” و”ما بعدها” على الصعيد الفنّي التعبيري. ولذلك كانت فكرةُ دمج الأجناس الأدبية أو تجاوزها حاضرةً إلى حدٍّ كبير. نشرتُ حينها ونشرتَ أنتَ وكذلك المرحوم محمد ولد عبدي نصوصاً غير قابلةٍ للتصنيف لا في القالب العمودي ولا في إطار قالب التفعيلة. ظهرتْ في الجريدة دون أن تَحمِلَ أيّ تصنيفٍ أي دون أن تُمنَح صفة الانتماء إلى أحد الأجناس الأدبية. ويمكن أن نُدرج في هذا الإطار النصوص التي نشرَها في زاويته الأسبوعية المرحومُ محمد تحتَ عنوان “تراتيل” (1987- 1988). ولعلّها وقتها الأكثرُ نضجاً كَشعرٍ خارج إطارِ تصنيفَيْ العمودي والتفعيلة.
– 4 –
لا شكّ أن الأوساط المعنية ـ “إنتاجاً” و”استهلاكاً” ـ بهذه النصوص كانت محدودة. إلا أنّ إصرارنا حينها على أن تكون نصوصُنا حاضرةً فيما اعتبرناه ـ ولو وهْمًا ـ مركزَ النقاش وتَـزامُنَ ذلك مع الظهور، إرهاصيًا، لبعض الفضاءات الثقافية والإعلامية، كلُّ ذلك أعطى الانطباع حينها بأنّ جيلنا كان قيدَ خلْقِ قطيعةٍ وتدشينِ مسارٍ حداثي مُسيَّق ومغروسٍ في قاعدة محليةٍ صلبةٍ.
مَنعني الانتقالُ إلى أوروبا من إمكانية المتابعة اليومية للحركة الأدبية الموريتانية مع انتهاء عقد الثمانينات. ولكن كما كتبتُ في النصّ التقديمي الذي نشرتُه مع ديواني “صلوات المنفى الباريسي” (1998) فإن انطباعي العامّ هو أنّ انعكاسات فشل “مشروع التحديث” كانت شاملة. لأُضفْ هنا أنّ ما يمكن استنتاجُه من الدراسات الموجودة أو على الأقل تلك التي اطّلعتُ عليها هي سرْعة انحسار ما كنّا نراه بسذاجة “مشروعاً تحديثياً”، سرعة انحسارِه مع بداية التسعينات، والعودة التْسونامية للذائِقة التقليدية إلى الواجهة.
– 5 –
من هنا قد نَفهمُ معنى رهانكَ هذا المحفوف بالمخاطر. مرّ ما يزيد على العقدين والنصف على تراجعِ تلك التجربة التحديثية. والذائقة التقليدية تزدادُ احتفاءً بانتصاراتها. ما الذي يعنيه إذاً قراركَ الحسمي بنشر هذا الديوان ؟ ما الذي يعنيه أن يَضمَّ عدداً من النصوص التي تعود إلى تلك الحقبة مع أخرى تُمثِّل استمراراً أو إثراءً لتلك التجربة؟ منذ البدايات لم تكن تحتاج إلى جرأةٍ أو جَسارةٍ خاصتين للخروج من القيود التواضعية. منذ البدايات كنتَ بطبعكَ غيرَ “منضبط”، موغلاً في البداوة وأنتَ تجلس على الأرض تمارس طقوسَكَ الإلكترونية بين أجهزتك المتنافِسة، وموغلاً في تكسير التابوهات ـ كأيّ مابعد حداثيٍ متطرّفٍ ـ رغم البروتوكولات الجدّ تقليدية وقواعد المحافظة الاجتماعية التي ما تزال تطبع بنسبةٍ معتبَرةٍ المجتمعَ الصحراوي.
– 6 –
في البدء يصف ديوان “البافور” نفسَه بأنه قصائد نثرية ثم يُدشِّن إداناته الذاتية بإعلانه المَطْلعي : “هذا ليس شعراً”.
لنتذكّرَ خلفية الأمر قليلاً فيما يمكن أنْ نُسمّيه، انتهاكًا، “تاريخَ” ما بعد الحداثة. في نهاية العشرينات من القرن الماضي، أي في حالة الحيرة التي اجتاحتْ أوروبا في فترة ما بين الحربين والتي عَرفتْ بين أشياء أخرى ظهورَ عددٍ كبيرٍ من التيارات الفنية، لفتَ كما هو معْروف الفنان البلجيكي رنيه ماغريت الانتباه إلى أحد أعماله التشكيلية الذي قد يبدو لأول وهلة أكثرها “بساطةً”. أعني طبعاً لوحتَه الشهيرة التي رَسَمَ فيها غليوناً وكتب تحته “هذا ليس غليوناً”. هكذا وبكلٍّ “سذاجةٍ” بدأتْ سنة 1929 قصّةُ “الغليون” التي ألهمتْ أجيالاً من الفنانين والمُنظِّرين خصوصاً ممن ارتبطتْ أسماؤهم بـ “ما بعد الحداثة” كعنوانٍ ظلَّ بالغَ الغموض ومتضارب التعريفات أو رافضاً لها.
– 7 –
ولكن العقود التي تلتْ ظهور لوحة ماغريت عرفتْ تسارعًا مفرطاً لـ”تاريخ” مابعد الحداثة كتاريخٍ ـ من وجهة نظرِ تصورّه الذاتي ـ مابعد تاريخي.
“العنوان لا يناقض الرسم؛ إنه يؤكِّده بشكلٍ آخر”. هذا ما أضافه ماغريت سنة 1966، بلغةٍ تُشْبه لغةَ ابن رشد حين يتحدَّثُ في “فصل المقال” عن أنّ “الحقَّ لا يُضادّ الحقّ بل يوافقه ويشهد له”. هلْ يعني ماغريت فقط ما يقوله لأن الفنّ غيرُ مُلزَمٍ بمبدأ الـلاتناقض؟ أو لأنّ الدالّ، بلغة المثلث السيميولوجيي، غير المدلول وغير المرجِع أو لأنّ اللفظ، باللغة البلاغية القديمة، غير المعنَى؟ ماغريت كتبَ جملتَه الإضافية هذه على مقلوب نسخةٍ من لوحته في شكل رسالة بَعثَ بها إلى ميشيل فوكو كتعقيبٍ على كتاب الأخير “الكلمات والأشياء”. ربما هذا ما دفع بديوان “البافور” ـ من منظور الوعي بأنَّ ما تسمح به لعبةُ تضادّ أو تَوافق الكلمات والرسم تَسمحُ به ربّما أكثر لعبةُ الرسمِ بالكلمات ـ إلى أن يضيف مَطْلعِياً لـ”إداناته” الذاتية : ” هذه الحروف ليستْ حروفاً “. بل وأن يزيد بشكلٍ أكثر راديكالية : “ولا نغماتٍ، ولا أوتاراً، ولا أي شيء..”.
– 8 –
“كُن ماء تكنْ شِعراً” أو كُن شعراً لِتكون ماءً وكنْ نثراً لتكون شعراً. فالشعر قد يكون الفضاء الوحيد الذي يعني فيه الاندماج “الهيغلي”، بين طرفيّ أيّ جدلية، اندماجاً سابقاً على تمايز الطرفين. بل الحديث عن الاندماج هو ذاتُه حديثٌ عن الشعر من خارج الشعر تماماً، كَكثيرٍ من مفردات البلاغة والنقد التي تُحاولُ أن تَصف الشعر بعباراتٍ عالِمةٍ تظلُّ في جمودها اللاشِعريّ بعيدةً عمّا يعنيه المَغْمَى الشعري وشراراته، عمّا تعنيه المحاولات الحثيثة لاختراق مجالات الـلامُعبَّر عنه. فالاندماج مثْله مثْل الكلام عن الدرجة الصفر من الكتابة، بالمعنى الذي استعاره رولان بارت من الألسنية الحديثة، أو الكلام عن الاوكسيمورون (الإِرْداف الخلْفي)، فهو يفترض أصلاً ثنائيةً جدليةً، أيْ يفترضُ انفصالاً أو تناقضاً بين طرفين. في أفق الشعر وفي زمن الشعر لا توجد ثنائيات تناقضية أو جدلية سابقةٍ على وحدتها أوْ واحديتها. زَمنُ الشعر هو “شهودٌ جامعٌ”. والحديث عن انفصال الشعر والنثر والتساؤل إن كانَ مثلاً هذا الديوانُ “البافور” شعراً أو نثراً أو شعراً نثرياً هو سؤالٌ غير مطروح بالمعنى الشعري. فالتقابُلُ هو بين النظم والنثر. أما الشعرُ وزمنُه فهما فيما يتجاوز ـ فيما يعلو على ـ مثْلِ هذه المُقابلات. فالشعر بهذا المعنى هو أفقٌ أو مثالٌ تعبيريٌّ وتَحقّقُه النسبيُ يعلو على الأجناس الأدبية بالمعنى التقليدي كأجناسٍ تسعى كلُّها إلى إثبات أدبيّتها عبْرَ تحقيق أعلى نسبةٍ ممكنةٍ لها من الشعرية.
– 9 –
في نظري الشخصي لا يمثّلُ ما يُسمى ما بعد الحداثة وما بعد مابعد الحداثة ـ بمختلف التجليات التي تُطلَق عليها هاتان التسميتان ـ إلّا مشاريع حداثية أيّا تَكنْ إحالاتها “التكتيكية” إلى “المابعد” أو “الما قبل”. ولكنّها قد تكون أحياناً، وليسَ دائماً، أكثرَ وعياً بِـالجوانب الإيديولوجية للحداثة وبالقدرة الضخمة للأساطير الحداثية على تسويق نفسها تحت عناوين إشهارية كالـ “العقل” و”التنوير” و”التقدّم”. تسميةُ ما بعد الحداثة أو ما بعد ما بعد الحداثة هي بذاتها انعكاسٌ لأوهام حداثية. لأنّ ” المابعد ” تُحيلُ إيتيمولوجياً إلى الخطّية والتحقيبية بينما المقصودُ ليس تجاوزاً خَطّياً وإنما إلغاءُ مفهومِ الخطية أصلاً، أو، بعبارة أدقّ، تفادي الفخّ الخطّي التحقيبي. والمقصودُ أيضا تفادي عموم الفخاخ المرتبطة بالأخير كفخِّ تصنيفِ الأجناس الأدبية الذي تُكرِّسُه النظرة المدرسية السائدة. ولذلك فإنّ المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تُتوقّع ممّا بعد الحداثة وممّا بعد ما بعد الحداثة ليستْ تَخطّي مرحلةٍ حداثية مُفترَضة للكتابة وللفنّ بل استعادةُ الإبداع لما به يكون إبداعاً بشكلٍ مستقلٍّ عن الزمن الاجتماعي.
– 10 –
الإبداعيةُ تعني بين أشياء أخرى تحريرَ الشعر من وثن المدرسية كيْ يستردّ قدرتَه على الخلق اللانهائي للإيقاع/الصورة وللصورة/الإيقاع، وبالتالي على خَلْقِ أوزانٍ بكرٍ وصورٍ ودلالات بكر، خلْقِ ما يعلو “الوزن” و”المعنى”. الخروجُ عن المدرسية والوعيُ بإكراهاتها في آن شرطان من شروط تجاوزها، ومن شروط تدشين الفاعلية الإبداعية. فالإبداعيةُ تعني تجاوزَ مُقايسةِ الشعر بمعايير خارجةٍ عنه. وهو ما يؤول بين أشياء أخرى إلى نهاية محاكمة الشعر عبْرَ ثنائياتٍ عدَمية الدلالة في أفق الشعر، كثنائية الشعر والنثر. يصبحُ إذاً الحديثُ عن شيء اسمُه قصيدةُ النثر حديثاً بلا دلالة. فهو، بداهةً، حديثٌ ليس له مكانٌ خارجَ مقولات البلاغة التقليدية واستعاداتها الحداثية وارتهاناتها لِخَطيّة ما دون زمن الشعر.
– 11 –
“هل غادر الشعراء من مُتردم ؟ ” … ” هل غادرتْ هل غادر الشعراء”…. هذان السؤالان، من عنترة ابن شداد إلى سيدي محمد الشيخ سيديّا، يكشفان إلى أي درجة يمكن أن يظلّ سؤال الإبداع محاصَراً بالاعتبارات الخطّية للـ”ماقبل” و”المابعد”، أي باعتبارات الزمن الاجتماعي. إذا كان لما بعد الحداثة ولما بعد ما بعد الحداثة منْ مساهمة فإنها يلزمُ أن تَعني أساساً إلغاءَ هيمنة الزمن الخطيّ، والمفردات المدرسية المرتبطة به، على زمن الشعر. الزمنُ الحداثيُ نفسُه هو تكريسٌ حدّي للخطيّة حين يتوكأ على السرديات والتحقيبات التي تدفعُ إليها تلقائياً أقانيمُ الخطاب الإيديولوجي للحداثة. والكلامُ التهكمي المابعد حداثي عن نهاية المعنى، ونهاية المؤلِّف أو موته وكلامُ ما بعد مابعد الحداثة عمّا بعد المؤلَّف وما بعد التهكّم كلّها تنويعات إشهارية تصدرُ عن نفس الرغبة التحقيبية.
– 12 –
ولكنَّ النصوصَ الإبداعيةَ كثيراً ما أظهرتْ بذاتها أنها غيرُ معنية بالتصنيف المدرسيّ. يبدو فعلاً أن التجارب الشعرية ذات الطابع الجدّي تبحث عن آفاق جديدة للمعنى، للصورة، للإيقاع إلخ. أي عن آفاق دلاليةٍ هي بذاتها آفاق ما بعد الدلالة. الشعرُ في هذا الأفق ليسَ شعرَ خيال وإنما شعر خلقِ الخيال، وليس هو شعرَ الوزن وإنما شعر خلقِ الوزن وخلقِ الإيقاع وخلقِ الصورة إلخ. بل هو بحثٌ عن تجربةٍ رياديةٍ تهتمّ أولاً بإبداع فضاء الممكنات الـلاممكنة. ما بعد الحداثة له تحديداً معنى أكبر حين يتعلّق الأمر بالشعر. لأن زمن الشعر هو زمنٌ إشراقيٌ، زمنُ التجليّات الـلازمنية. أي أنَّ زمن الشعر يختلف راديكالياً عن الزمن الخطّي.
– 13 –
ندركُ هنا إذاً أنَّ طوق الحمامة مثلاً هو بالمعنى الإبداعي نصٌّ شعري حداثي وما بعد حداثي … بينما عددٌ من “قصائد” أدونيس أو محمد بنّيس، إذا اقتصرنا على الأمثلة العربية، هي “قصائد” تقليدية لا شعرية. يمكن أن يُقال عنها حرفياً إنها خارج زمن الشعر وإذاً خارج أفُقه، رغم ما يقوله مؤلفاها لتسويقها. فكأنهما يؤمنان بقوة سحرية لنوع من النبوءات الذاتية الماغريتية يكفى معها أن يقال عن أي شيء ـ مثلا عن أيّ قطعةٍ منسيةٍ على الرصيف وعن الرصيف نفسه ـ أيّاً يكن : هذا غليون، ليصبح غليوناً. ويمكن طبعاً أن يقال هذا عن عددٍ ممّا يُقدّمه نشطاء ما عُرف في الخمسين سنة الأخيرة بالفنّ الشعبي (بوب آرت) تحت شعار إلغاء الفنّ المعاصر للحدود بين الفنّ والـلافنّ. أعني ما يُقدَّمُ كأعمالٍ “تشكيلية” أو “نحتية” يقف حصرياً انتماؤها للفنّ على إعلانها الذاتي : هذا فنّ.
– 14 –
في كتابه “هذا ليس غليوناً (1973)” ألحّ فوكو على أنَّ هذه العبارة ـ التي جعلَ منها عنواناً لكتابه ـ من حيث هي مَنصوصةٌ مع الرسم في لوحة ماغريت “تأخذ القولَ بدورها لتقول عن نفسها : “هذه الحروفُ التي تُكوِّنُني والتي تنتظرون منها، في اللحظة التي تبدؤون في قراءتها أنها ستُسمِّي الغليون، هذه الحروف، كيف تتجاسر على أن تقول إنّها ليستْ غليوناً، وهي البعيدة جداً عمّا تُسمّيه”. لنفترض أن أحد العوامل التي تسمح بكلمتيْ “البعيدة جداً” يكمن في المسافة بين الرسم والكلمات. بالنسبة للشعر قد لا يكون ذلك كذلك على الأقلّ إذا أخذنا على محمل الجدّ التمييزُ الذي يعتمده جيل دلوز، تعليقًا على كتاب فوكو، بين الشكل المرئيّ وبين الشكل المنصوص. المسافة التي يتحدثُ عنها دلوز قد تكون وجيهة حين يتعلّق الأمرُ بالمنصوص والمرسوم. ولكنّ المسافة بين الشكلين تنمحي حين يتعلّق الأمر بالشعر إذْ هو منصوصٌ مرئيّ على الأقل في صيغته المكتوبة. والواقع أنّ فوكو يركّزُ من خلال لوحة ماغريت على علاقة “الأيس″ (أو “الكائن” أو “الموجود”) واللغة، أي علاقة التَـمثُّلِ، عمليةً ونتاجاً، بالمُتَمَثَّل أو، تجاوزاً، بالمُمَثَّل. وطبعاً يُشكِّل التساؤل القديم الجديد حول هذه العلاقة المحورَ الذي تدور حوله أغلب تيارات ما بعد الحداثة.
– 15 –
ولكنَّ تعبير “هذا ليس شعراً” كجزءٍ من ديوانٍ وكعبارةٍ تتصدّر ديواناً أي كشعرٍ ينفي عن ذاته وعمّا يتصدَّره صفةَ الشعر، هو تعبيرٌ يحمل تساؤلاتٍ أكثر تعقيداً. أوّلُها يتجاوز علاقةَ الأيس واللغة إلى علاقة اللغة باللغة، أي علاقة الأيس اللُّغوي بنفسه. ويتجاوزُها بصفةٍ أكثر إلحاحاً إلى علاقة لغةِ الشعر، كلُغةٍ حدّيةٍ داخل اللغة، مع ما به تكون لغةُ الشعر كذلك. لغةُ الشعر هي أولاً فتحٌ لباب الممكنات ولباب التجديد “المستمِرّ” ـ قطيعةً بعد قطيعةٍ ـ للذائقةِ الأدبية، لجماليةِ الإنتاج/التلقّي، لزمنية الكتابة/القراءة، لِقوْلِ ما يخترق القولَ، للتعبير عمّا يَقْـصر عن التعبير ويكبُرُه في آن، لاختراع ما يفيضُ عن المعنى أو يعانده : اللامعنى ومعنى المعنى. في هذا يسعى الديوان بإعلانه “هذا ليس شعراً” إلى قلبْ معادلةِ ماغريت ليصوغها بشكل آخر وكأنّه يقول مع بعضِ المُتكلِّمين القدماء : الاسم غير المُسمّى. ثم ليقول تزامنيا مع مناهضيهم : الاسم هو المُسمّى. لنقل نحن، إذاً، إنَّ هذه القصائد ليستْ نثريةً وليستْ غير نثرية. إنّها شعرٌ يستعيد شعريته عبر “شهودٍ” جامعٍ لا يتنازل عن أي مرتبة ممّا يسميه المتصوفةُ “مراتبَ الوجود”. وهي إذاً من حيث هي شعرٌ تتجاوز ـ أو بعبارة أدقّ تعلو على ـ هذه الثنائية.