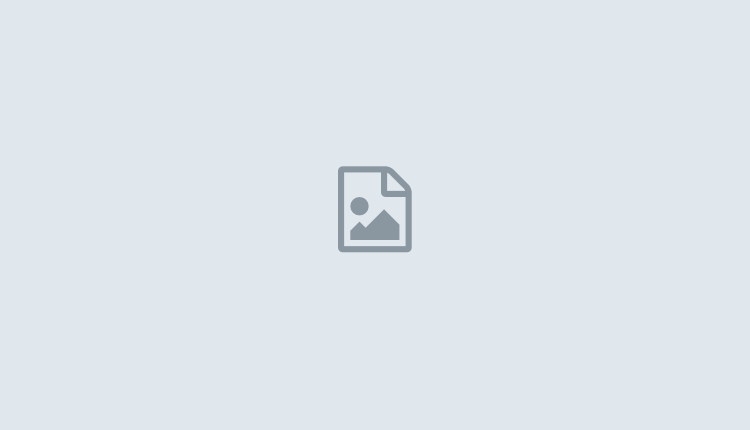أحمد اضصالح: الحب السائل.. في زمن اللايقين الادبي والانساني
أحمد اضصالح
يقولون، إن الحب يداهم الناس كما يداهمهم الموت على حين غفلة، هو شيء يستقر بين الضلوع دون أن يُخبرك، يأتي فجأة فيقهر كل التحديات، يجعلك تنسى كُل خطايا الحبيب، لتتعلق بأهدابه كأنه ملاك لا شبيه له، فتنشد وُدّه بشتّى الوسائل والحيل..
هو الذي أبكى “مُغيث”ا –ذلك العبد المسكين في مُجتمع المدينة المُنوّرة- حتّى جرى الدّمع على لحيته حين طلّقته امرأته “بريرة”، فقال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم لعباس بن عبد المُطّلب: “يا عبّاس، ألا تعجب من حُبّ مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟!”.
وفي الأدب، هو الذي داهم “محمود درويش” قبل أن تحمل حبيبته البُندقية في وجه وطنه، فما استطاع أن يستمرّ، ليدمع قلمه قصيدة مُوجعة:
“آه .. ريتا
بيننا مليون عصفور وصوره..
ومواعيد كثيره..
أطلقتْ ناراً عليها..
بندقيّهْ”.
وهو الذي أجبر “قيس بن الملوح” على أن يهيم في الأرض منشدا:
“ألست وعدتني يا قلبُ أنّي اذا ما تُبتُ عن ليلى تتوبُ
فها أنا تائبٌ عن حُبِ ليلى فما لك كلما ذُكرت تذوبُ”
وهو الذي لمّ شمل عائلتين عريقتين ب”فيرونا” الإيطالية يكادُ البُغض أن يقضي على كل أمل وصل بينهما، بعد أن ارتبط “روميو” ب”جوليت” حسب الأديب الإنجليزي “وليام شكسبير”.
هو إحساس لا يُمكن تعريفه إلاّ ب”الحبّ” نفسه، أسمى شعور يغشى النّاس وهم أحياء، يُحاولون أن يُوهموا أنفسهم بإقباره، لكنّهم ما استطاعوا.
كثيرون يدّعونه عندما تستبدّ بهم رغبة الشّوق وتقترف قلوبهم مُتعة الحنين، وكثيرون اعتبروه سحابة صيف، مُستهينين بخُطوبه، فلمّا وقعت أرجلهم في شركه، واستحكم قلوبهم تغيّرت ملامح حياتهم ومعاشهم دونما تخطيط مُسبق.
رُبّما هذا هو الأصل الذي حكم العلاقات البشرية في إطار “الحُبّ” فطريا، والذي يجب أن يستمرّ ويدوم، لكنّ تناقُضات الأزمنة والأجيال أظهر الكثير من النّقائص والعيوب في فنون التّعامل مع هذا الشّعور النّبيل.
في واقع “ما بعد الحداثة”، تغيّرت الكثير من المُعطيات، وجرت مياه تحت الجسر، فما عاد الحُبّ حُبّا كما عاشه “مُغيث”، وتصوّره “محمود درويش” وتمثّله “قيس بن المُلوح” وجسّده “روميو وجوليت”.
تغيّر كما هو الحال بالنّسبة لأشيائنا، وأحوال معاشنا، وعاداتنا، وطريقة تفكيرنا، فصار الحُبّ يُعاش على قدر من الرّبح والخسارة، يقُومُ عادة على المصالح المادّية، والتّأقيت والمدى القصير الذي تقوم عليه حسابات المُجتمع الاستهلاكي الحديث..
يكفي صراعُُ تافه بين الحبيبين لتنتهي قصّة الحُبّ كما بدأت أوّل مرّة تافهة أيضا، حول ضغطة إعجاب في الفايسبوك أو احتراق طعام، أو “موضة” لم يُحسن فيها الزّوج الاختيار…، فتراكمت الملفّاتُ التّافهة بدورها في ردهات المحاكم دون حلّ يبدو في الأفق، تتغذّى على بُؤس “ما بعد الحداثة” و”الحياة السّائلة” –حسب زيجمونث باومان- ، إلى أن تنتهي العلاقة بين الحبيبين على شكل حذف من “قائمة الأصدقاء”، وإعادة ربط علاقة أخرى برهانات ربحية استهلاكية أكثر من سابقتها وهكذا..
أزمة “الحُبّ السّائل” هذا، يكمن في إنهاك النّفوس بصراع تطويع ما لا يُطوّع، وحصر المشاعر الإنسانية في الأجساد التي يُصيبها الملل، فيضطرّ أحد الأطراف مُجبرا إلى الزّهد في الآخر مع مُرور الوقت.
إنّ الوُقوع في شرك الحبّ والخروج منه تبعا لهذا المُعطى –حسب باومان- وعد بتحويل “تجربة الحُبّ” إلى سلعة، فالتصق الحبّ بكافّة العلاقات العابرة التي تتنافى والمعنى الحقيقي له، تحت ذريعة التّجربة، فسهُل التّخلّص من هذه العلاقة، كما يتخلّص النّاس من النّفايات غير المرغوب فيها، بسهولة تامّة، وكأنّنا إزاء تجارة جديدة تتأسس على التّخلّص من الّسلعة كُلّها عوض إصلاح الأعطاب وإعادة توظيفها.
هذا المنطق الاستهلاكي أفقد معنى “الحُبّ” الذي وصفه عميد الأدب المصري “طه حسين” في إحدى أحاديثه: “الحُبّ سيل جارف لا يمرّ بشيء إلا اكتسحه اكتساحا…، قاهر بطبعه، قاهر للنّاس وقاهر للأشياء، وقاهر للأحداث والخطوب أيضا”.
ما عاد الحُبّ قاهرا في غالب أحواله، بل بات مقهورا بأبجديات المادّة، وغلبة الرّغبات الجسدية، وخداع المظاهر، وضعف المبادئ والقيم في زمن اللاّيقين، فتلاشت الكثير من المُعطيات وبرزت أخرى تبعا لظروف اقتصادية واجتماعية لا تخفى على أحد.
أستاذ باحث مغربي